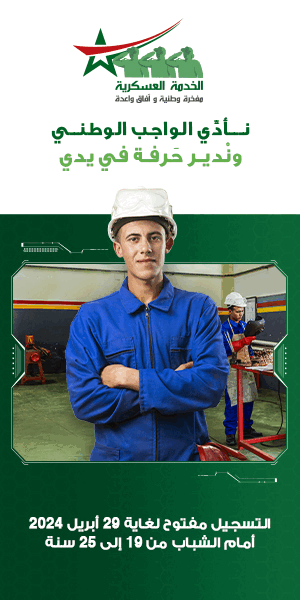أبطال البلوكاج الحكومي أخنوش ولشكر تركوا القصر في ورطة أمام حراك الريف

مواقع
القصر “وحيدا” أمام “حراك” الشارع.. أين أخنوش ولشكر وأصدقاهم الذين ""صالوا وجالوا"" في البلوكاج الحكومي.. لماذا أصيبوا بالخرص؟ أين الكفاءة السياسية لحل المشاكل؟....؟
أظهرت مسيرة أمس الأحد في الرباط، (لمن في عينيه رمد)، أن “ممارسات السلطة”، من خلال سعيها إلى التحكم في المشهد السياسي، لم تحقق النتيجة المرجوة، وأن السلوك السياسي للسلطة، الذي ميز السنتين الماضيتين، ابتداء من الانشقاق الحكومي سنة 2013، مرورا بانتخابات 2015 الجماعية، إلى ما بعد انتخابات 2016 التشريعية، وما أعقبها من “بلوكاج” سياسي، وإخراج لحكومة أبريل، كان شبيها بإخراج “سيتكومات” رمضان، التي يتابعها المغاربة هذه الأيام.
لقد كشف “حراك الريف” وما رافقه من تطورات متسارعة، أن أغلب الأحزاب السياسية “المشاركة” في اللعبة الديمقراطية، أصبحت تنظر إلى العملية السياسية، كفرصة للانقضاض على الغنائم فقط، أما الانغماس في قلب المشاكل المجتمعية، والسعي إلى الانخراط في مهمة إيجاد الحلول للإشكاليات العويصة التي تواجه المجتمع، فتلك مسؤولية يرمونها بكل “وقاحة” في حضن المؤسسة الملكية، ويتراجعون إلى الوراء ليتحولوا إلى متفرجين، مثلهم مثل أي مواطن بسيط “لا حول ولا قوة له”.
لقد فضح “الحراك” المجتمعي في منطقة الشمال، الفاعلين السياسيين “الرسميين”، وأظهر أنهم فقدوا كل صلة لهم بالشعب، ولم يعودوا يمثلوه، وفقدوا كل مصداقية بسبب “تلوناتهم” المتكررة، وتنكرهم لأقوالهم ومبادئهم التي سطروها بأيديهم، ولم يعودوا تلك الوسائط التي تحدث عنها الدستور، وتخلوا عن دورهم الذي حدده لهم القانون الأسمى في المملكة، وهو تأطير المواطنين، والتعبير عن مطالبهم والعمل على إيصالها إلى مراكز القرار، بطريقة تجعل المرور من مستوى(المدخلات، المطالب) إلى (المخرجات، القرارات)، عملية سلسة، ولا تنتج عن اصطدام، كما هو الحال في البلدان الديمقراطية، التي تتوفر على مؤسسات للوساطة وعلى تمثيلية حقيقية لمكونات المجتمع، وليس خريطة مصنوعة على المقاس، وفاعلين مفروضين ولا يمثلون حتى أنفسهم، وينكشف زيفهم، مع أول “قطرة” من المشاكل تسقط فوق رؤوسهم. بل الأفظع من ذلك هو ظهور كائنات سياسية تتاجر في الأزمات، وتحاول استغلال الظروف، من أجل توجيه الضربات تحت الحزام إلى خصومها، بهدف التأكيد على كونها الشخص “الضرورة”، الذي بيده الحل والعقد لكل مشاكل البلد. وقد تابعنا مبادرات للمساهمة في حل المشكل بعد فوات الأوان، وبعد أن أصبح النشطاء وراء القضبان.
أخنوش صاحب “أغراس أغراس”، الذي جاء إلى الأحرار، من أجل إعطاء دفعة قوية لحزب، كان دائما في صف السلطة، وطار من إقليم إلى آخر، من أجل “بناء حزب جديد ملتحم بالمواطنين ويستمع إلى شكاويهم، وأسس قطاعات نسائية وشبابية في فنادق خمسة نجوم، من أجل الاقتراب من هذه الفئات”. لماذا لم نراه يتجه إلى الحسيمة، بصفته الحزبية، (وليس الوزارية، و بأمر ملكي)، ويستمع إلى الشباب هناك من نشطاء “الحراك”، بدل إصدار بيانات للمكتب السياسي، -(من المفترض أنها بلاغات حزب، يمثل المواطنين، ويؤطرهم، وينقل مطالبهم إلى مراكز القرار..)-. “بيانات” متطابقة مع بلاغات الحكومة، والتي ظهر جليا تذبذبها في التعاطي مع الاحتجاجات، فهي من جهة تعترف أن مطالب “الحراك” مشروعة، ومن جهة تعتقل النشطاء الذين يرفعون هذه المطالب. لماذا لم يظهر أخنوش وهو الذي يتم تقديمه كقائد وزعيم، لجزء كبير من المشهد السياسي المغربي اليوم، بأي مبادرة “لحلحلة” ملف الحسيمة، وتقريب وجهات النظر بين المحتجين وأصحاب القرار.
أما ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، فقد أعلن انفصاله عن القوات الشعبية، منذ زمن طويل، وأصبح بعيدا عن قضايا الشارع، بل وينظر لها بازدراء كبير، لأنها تخلق له دائما مشاكل داخلية هو في غنى عنها، حيث يرتبط كل احتجاج في الشارع، بأزمة داخلية داخل الاتحاد، منذ حراك 20 فبراير وإلى أحداث الريف اليوم، وما خرجة رئيس فريقه بمجلس النواب، الذي وصف مطالب الريف، بأن جزءا منها قد يكون “غير واقعي، ومجرد أحلام”، وهو المعروف عنه أنه مجرد “ناقل صدى” لكاتبه الأول، وما بيان الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بالحسيمة، الذي “أطلق النار” على رئيس فريقه بسبب مداخلته تحت قبة مجلس النواب، إلا دليل على مدى الإزعاج الذي تشكله احتجاجات الشارع لقيادة الاتحاد الاشتراكي الجديدة- القديمة. دون أن ننسى تصريح لشكر ضمن تصريحات أحزاب الأغلبية الحكومية التي اتهمت نشطاء “الحراك” بالانفصال وتلقي تمويلات من الخارج. أين اختفت الفكرة اليسارية للاتحاد الاشتراكي وقدرته على تعبئة الأحزاب اليسارية في إفريقيا والعالم، التي “خولته” الحصول على رئاسة مجلس النواب وحقائب وزارية، بعد ستة أشهر من مسرحية “البلوكاج”، لماذا لا يستطيع اليوم استغلال تاريخه ورمزية الحزب وقادته، من أجل النزول بمبادرة قوية، تسعى إلى الوساطة من أجل إيجاد حل لأزمة الريف.
في حين لازال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لم يستيقظ بعد من “أحلام شهر العسل الحكومي، بعد تلقيه لهدية رئاسة الحكومة، وهو الذي لم يكن ينتظرها”، ولا يرغب في إزعاج نفسه وتحمل مسؤوليته، فيما يقع في شمال المغرب، و”تنازل” عن كل اختصاصاته لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، الذي تطارده لعنة “تجزئة خدام الدولة”. والذي “رسم” السيناريو بأكمله، فبعد بلاغ أحزاب الأغلبية الحكومية، الذي اتهم نشطاء الحراك بالانفصال والتبعية للخارج، عادت الحكومة “لتعترف” بمشروعية المطالب “تحت ضغط مسيرة الخميس”، وفي نفس الوقت جهزت زنازن سجن عكاشة الانفرادية لاستقبال قادة “الحراك”، بعد خطبة الجمعة التي أرسلها أحمد التوفيق، لإشعال الفتنة وإحراق النشطاء بنارها.
الحكومة انساقت وراء الحل الأمني (ولو بقفازات من حرير، من قبيل احترام مدة الحراسة النظرية، وضمان اتصال المعتقلين بعائلاتهم..)، لكنها، بقيت وفية لنفس عقيدة ومنطق الدولة، الذي لا يقبل بالتحاور أو بالأحرى التفاوض، مع من تعتبرهم “متمردين” على هيبة “المخزن”، وليس مواطنين، يحتجون من أجل مطالب مشروعة، تكفلها لهم القوانين الوطنية ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.
واليوم نتابع الجميع يدعو إلى تدخل ملكي، من أجل الخروج من المأزق، عائلات المعتقلين، ومن تبقى من النشطاء خارج السجن، وكافة المحتجين، لم تعد لهم ثقة في أي مؤسسة أخرى، ويدعون إلى تدخل ملكي، الفاعلون السياسيون من خارج اللعبة، والحقوقيون والكثير من المثقفين، يدعون إلى ضرورة التدخل الملكي، البرلمان اكتفى بمنطق، “ليس في الإمكان أبدع مما كان”، فبعد جلسة للمساءلة يمكن إدراجها في جنس “الكوميديا السوداء”، خرج العديد من البرلمانيين، آخرهم عبد اللطيف وهبي عن “البام” للدعوة إلى تدخل ملكي. فما الجدوى إذن، من وجود أحزاب سياسية، وتنظيم انتخابات دورية، وتشكيل حكومة، وخلق مؤسسات دستورية من المفروض أن دورها، هو تحقيق الوساطة بين المجتمع والدولة. ألم يحن الوقت بعد للانتقال إلى دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات؟.
-

قريبا ، ولهذه الأسباب ... إحالة رؤساء أحزاب وقياديين بارزين على القضاء
-

استغل منصبه للإيقاع بضحاياه ... قصة نصب كبرى بطلها موظف سامي
-

خبر سار ... عطلة جديدة في الطريق هذه مدتها وهؤلاء من سيستفيد منها
-

قياديين بارزين في قلب فضيحة نصب واحتيال هذه تفاصيلها الكاملة
-

يرويها رئيس الحكومة السابق بنفسه ... قصة غضبة ملكية على سعد الدين العثماني
-

يرى النور بعد العيد مباشرة . خبايا اول تعديل حكومي بعد انقضاء نصف ولاية حكومة أخنوش
-

المغاربة غير راضين عنها ... هذه حصيلة حكومة أخنوش بعدما أتمت نصف ولايتها الأول
-

حكومة أخنوش تصدم آلاف الأسر المغربية بهذا القرار بعدما أسعدتهم للحظات
-

وأخيرا ... قضية المنصوري و مضيان في طريقها للحل ، هذه آخر التطورات
-

تعرفوا على آخر قرار هام جديد لوزير الداخلية يهم الاسرة المغربية
-

الرضيع الذي لم توقظه تصفيقات الحاضرين ... قصة برلمانية مغربية تلقي كلمة في الامم المتحدة حاضنة ابنها النائم
-

التشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة واستغلال النفوذ... فضيحة سياسية جديدة أمام القضاء
-

صادم ... قصة السياسي الذي اطاحت به نصف دجاجة و 200 درهم
-

أخنوش في قلب فضيحة جديدة ... هل يستغل رئيس الحكومة منصبه ليراكم الثروات ؟
-

صادم .... ما لا تعرفونه عن آخر فضيحة مدوية لحزب رئيس الحكومة
-

البيجيدي يخرج عن صمته بخصوص اتهام أحد أهم وزرائه السابقين وهذا رده الناري
-

استمرار لهيب الأسعار مع اقتراب شهر رمضان .القضية تصل البرلمان فهل سيتدخل ؟
-

جديد قضية الناشط رضى الطاوجني . هذا ما قضت به محكمة أكادير في حقه
-

مركز حقوقي يخرج عن صمته بخصوص دعوى وهبي ضد المهدوي وهذا نص بلاغه الناري
-

المهداوي في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وهذه بعض ملامح التحقيق
-

صادم ... تفاصيل لا تعرفونها عن الثروة التي راكمها أخنوش مؤخرا
-

لائحة أسماء جديدة تم تعيينها في مناصب مسؤولية عليا تعرفوا عليها
-

أخبار سارة ... هذه هدية حكومة أخنوش للمغاربة أسابيع قبيل حلول شهر رمضان المبارك
-

عزيز رباح يخرج عن صمته بعد اتهامه بكونه سبب عطش المغاربة وهذا رده الناري
-

قاضي التحقيق يأمر بسجن قيادي بارز من هذا الحزب
-

تهم خطيرة تواجهها ... زوايا و أضرحة في قفص الاتهام
-

تهم خطيرة تواجهها ... زوايا و أضرحة في قفص الاتهام
-

الداخلية تقود حركة تعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال هذه بعض ملامحها
-

وأخيرا ... تعديل حكومي مرتقب هذه ابرز معالمه
-

ما لا تعرفونه لائحة التعديل الحكومي المرتقب والتي هزت وسائل التواصل الاجتماعي